بحـث
المواضيع الأخيرة
تأملات للزمن الفصحي
النوفلي :: المواضيع الدينية :: عظات
صفحة 1 من اصل 1
 تأملات للزمن الفصحي
تأملات للزمن الفصحي
تأملات للزمن الفصحي
سيادة المطران بشار متي وردة
سيادة المطران بشار متي وردة
مواعظ الأسبوع العظيم 2011
عيد السعانين: تبارك الآتي باسم الرب
متى 20: 29- 21: 22
يدعونا ربّنا يسوع اليوم لنتبعه وهو يدخل أورشليم باحتفالٍ مهيب، هيّئه أطفالٌ وبُسطاء الناس إذ فرشوا الثياب، وحملوا أغصان الزيتون وسعفُ النخيل مُحيينَ الملكَ الآتي ليُعلنَ الإنتصار والسلام صارخين:"هوشعنا ي إبنَ داود: خلصنا يا ابن داود". نداءٌ من ضعفاء ومساكين لم يرغبوا في أن يكونوا متفرجين، بل حوّطوا ربّنا يسوع وأرادوهُ مُخلّصاً، وكلٌّ منهم يُريده مُخلصاً لأزمة يُعاني منها. عيد السعانين: تبارك الآتي باسم الرب
متى 20: 29- 21: 22
موكب يسوع اليوم موكب خلاص؛ موكبٌ يريدُ خلاصنا. خلاصنا من كبريائنا، من جوعنا إلى التسلط والاحتكار، فيُطلقنا أحراراً من تعلقاتنا لنكون صادقينَ أمام الله وأمام أنفسنا في أننا لا نعبدُ إلا إلهناً واحداً. ومن أجل أن يتحقق هذا الإنتصار، دعانا الله لزمنِ توبةٍ في صومٍ أراده جواباً صادقاً منّا كي يكون تعبّدنا حقيقي. فالكنيسة تُعلمنا في زمن الصوم لا أن نجوّعَ بطوننا فحسب، بل أن نشعر ونختبر الجوع إلى الله. أن نُفرّغ لله مجالاً في حياتنا، فيكونَ هو الكل في الكل.
ربّنا الذي يُريد أن يُخلصنا من مخاوفنا، يأتينا اليوم متواضعاً لئلا يُخيفنا، يأتينا برأفة وحنانٍ ويمد يده ليشفي عمانا فنحيا ونُشارك ونتقاسم الحياة بفرح مع الآخرين. فموكب يسوع لا يُخيف، فلا جنود ولا حرس ولا مركبات تتقدّموه. بل جحش وأغصان سلام وأناشيد شكر وفرح. هذه هي علامات ملك متواضع مُسالم، سيُغيّر العالم ببشارته.
كان الجنود الرومان في مثل هذه الأيام يتحفظون ويمنعون كل تجمّع واحتفالية تحسباً لتمرد وثورة. لكنهم فهموا سلامةَ ومحبةَ موكبِ يسوع، فلم يمنعوه، ولم يقف أحدهم ممانعاً إلا مَن رفض الخلاص، وحركته مشاعر الحسد فالبغض والحقد فأخطأ، وسيسقط في بسبب حقده وحسده، لأن الإنسان، كل إنسان، كلّما كُلّفَ بمنصبِ أو مهمةٍ وَجَبَ أن يكون أكثر إهتماماً بإخوتهِ، فيكون حُراً لا عبداً لمشاعره ورغباته.
يروي لنا آباؤنا الروحيونَ قصّةَ شخصٍ كان يكره جاره جداً لمخاصمة عتيقة حصلت بينهما. اتفق أنه اعتلى منصب الوزير عند ملكٍ يسمع له باهتمام، فاستغل الوزير منصبهُ ليُوقِعَ بمَن يكرره، فأعدَّ مكيدةً طلب فيها الملك بأن يحضرَ جاره أمامه كونه يصنع المعجزات، وهو إفتراء وكذب كبير أرادَ به هلاكَ جاره بدافعِ الإنتقام، فأرسل الملكُ إلى عائلته يُعلمهم بالخبر وفي حال عدم حضوره ستُعتقّل العائلة كلّها وتُقتل.
صلّت العائلة إلى الله وقدمت الصوم ليُنقذهم من هذه المكيدة، وجلس الشاب في اليوم الثالث يأكل وكأن شيئاً لم يكن. سألوه عن سبب لامبالاته فأجاب: "خذوني إلى الملك"! سيقتلك! قالوا له. قال: "لا يهمكم سأتدبّر أمري".
أحضروه عند الملك وجلس الوزير بجانب الملك وقد علّت على وجهه ابتسامة خبيثة. سأله الملك هل أنت فلان. فأجاب: نعم. فسأله الملك: اي معجزة لك أن تقدمها لنا. فقال الشاب: أحضر لي هنا برميلاً كبيراً من الزيت المغلي، وليغطس فيه الوزير لمدة ساعة، وأنا أؤكد لك بأنه سيخرج حيّا، شاباً كلّه نشاط وحيوية. أدركَ الوزيز حينها أنه سقط فيما حفرَّ لأخيه فأقرَّ بخطيئته أمام الحاضرين.
التواضع هو ما ينقصُ الإنسان دوماً، وغيابهُ غيابُ الإنسانية من قلوبنا، وفهمت الكنيسة أهميّة التواضع لا سيما لأولئكَ الذين يُكلفونَ بمهامِ رعاية شعبِ الله، لذا، وكلما احتفلت بتنصيب بابا جديد تُحضّر إحتفالية مهيبة، وموكب عظيمٌ للبابا الجديد من قصر الفاتيكان حتى كنيسة القديس بطرس حيث يسير البابا الجديد وسط جموع تهتف وتصلي من أجله. ولن هناك شمّاسٌ يتقدم البابا يحملُ إناءً فيه قطعة قطن مُحترقة يُريها للبابا الجديد بين الحين والآخر وهو يُردد له: هكذا يزول مجد هذا العالم. كلها لكي يُحافظ البابا الجديد على تواضعه ويتذكّر أنه إنسان مثل باقي الناس واختير للخدمة فحسب. وملكنا اليوم هو مُعلمنا. العميان والخُرس والبُكم والمجروحون الذين شفاهم لا يُريدهم جنوداً وحرساً له، بل رُسلاً مُبشرين رسالة سلام ورحمة.
يأتينا يسوع يطلب منّا السير مع الموكب. يُريدنا مستعدين لا للغناء بل لنُرتل، ففي الترتيل صلاة وشكر وامتنان لخلاص نختبره. خلاص من أنفسنا، من أنانيتنا، من رغباتنا من طموحاتنا القتّالة. يُطهرنا بكلام الشكر، ويُباركنا للخدمة والرحمة. فما لنا أن نفهم دخول يسوع إلا بفهم تطهيره للهيكل. وإذا كنا نريد السير خلف يسوع في سعانين فرح وشكر، فلنستعد لأن يدخل قلبنا مُهراً مُخلصاً ليُؤسس ملكوت الله فينا وبيننا. مملكته ليست مثل مملكات هذا العالم. وسلطانه ليس سلطان احتكار وسلب بل دعوة لُنحضر القلوب ليسكن فيها، ويصل بها إلى قلوب المساكين. فإلى جانب مَن سنقف اليوم: الأطفال المُنشدين، أم الفريسيين الغاضبين؟
خميس الأسرار : وبينما هم يأكلون
مر 14: 22 – 26
العشاء الأخير هذا ما تعوّدنا على تسمية على حوادث هذه الليلة به، والحقيقة هي أن الرب يسوع أرادَ أن يكون هذا العشاء الذي فيه كسر الخبز بين تلاميذه بداية للقاءات كسر الخبز، وقداساً أبدياً. فلن يكون عشاءً أخيراً بل فاتحة لقداسٍ يجمع فيه ربّنا كنيسته من مشرقها ومغربها، لتكون حول مائدته، تتأمل كلمته، وتكسر الخبز وتتقاسم كأس الشكر فتعيشه بشارة في حياتها. مر 14: 22 – 26
قداس يسوع بدأ يوم التفت الله إلى عالمنا فهيَّأه بكلمته: فقال الله: ليكن نور فكان نور. هذا القداس تواصل ليحتضن كل تاريخنا الإنساني، كل آلامنا، أفراحنا، همومنا وتطلعاتنا. قداس أراده إلهنا عهداً أبدياً بين الله وشعبه، فقدّمَ ذاته ليكون الوسيط، المذبح والذبيحة. قُداس يسوع بدأ يوم قدّم نفسه شافياً، مُرشداً، مُهتماً بالصغير والكبير، بالمرفوض والفقير. قداسه بدأ يوم أعلن أنه جاء ليزرع حب ملكوت الله في عالم يتصارع ويتقاتل ليتسلّط ويحكم. تحدّاهم ربّنا بأنه قادرٌ بالضعفاء والفقراء والصغار أن يبني الملكوت. بيد المُصالحة والمُسالمة، فتكون ذبيحة القداس محبة تصل وتشع في حياة البعيد ليقترب ويختبر حب الآب. فكلُ ما فعله كان من أجلنا.
ربما سمعتم عن شابٍ من جنوب أفريقيا، الذي ذهب للكاهن بعد أن أنهى دروسه الإبتدائية يسأله أن يدخل الدير ليُصبح كاهناً. فكانت فكرته مُفرحةً جداً لكاهن رعيته إلا أن الكاهن بيّن له صعوبة إتمامها؛ كون الرعية لا تملك مبلغ 60 استرليني رسم الدخول إلى الدير لتدفع له. فعاد الشاب ليقول بحماس: عمري 14 سنة يا أبونا، وأنا مستعد للعمل في المناجم لأوفّر هذا المبلغ في مدة سنتين. وكان ذلك ما حصل بالفعل.
بعد سنتين عاد الشاب وكلّه حماس وفرح، فقد اقترب من أن ينال ما يطمح إليه. وكشف للكاهن عن ثبات العزيمة ورغبته الشديدة في مواصلة المسيرة نحو الكهنوت قائلاً: "هوذا المبلغ يا أبتي ..." فرح الكاهن ولكنه لمحَ فيه اصفرار الوجه وسعال غريب فأرسله إلى طبيب ليفحصه قبل أن يُرسله إلى الدير.
كتب الطبيب إلى الكاهن: يُؤسفني يا أبتي أن أخبرك بأن الشاب لن يعيش أكثر من سنتين أو ثلاثة. فالعمل في المناجم أثّرَ عليه كثيراً وأصابه داء السل. جاء الشاب يستطلع النتيجة وعيناه أغرورقتا بالدموع، وسأل الكاهن: أبتِ! كم يتبقى لي من العمر؟ - سنتان يا أبني، أو ثلاث!
تكفيني سنتان يا أبتي! أجاب الشاب، ثم أكمل: "سأعود للعمل في المناجم لأوفّر مبلغ 60 استرليني حتى يتمكن صبيان من الدخول إلى الدير والاستعداد للكهنوت بدلاً مني!.
قصة هذا الشاب تُظهر لنا معنى رسالة ربّنا يسوع المسيح، إنه جاء ليرفعنا إلى الآب، ضحى بحياته كي ننعم بالسلام مع الله أبينا. قدّم نفسه ليكون هو سلامنا مع الله. فصار هو عهدنا مع الله. ما معنى ذلك؟ وكيف نفهم وساطة ربّنا يسوع للمُسالمة مع الله؟
لم يُفكر ربّنا يسوع في تقديس ذاته فحسب، بل بشّرنا قائلاً: وأنا اُقدّس نفسي من أجلهم". صار تعلّقاً بالله فالتصق به وجعل حياته كلّها مجالاً لله ليعمل من خلاله بين الناس. جعل من كل لحظة في حياته فرصة ليلتقي الله بنا، فصارت حياته مُشبعَة بالحضور الإلهي. أحب أن يُحِب مهما كان التكاليف. أطاع وتضامن مع الناس من دون أن يفتكر بالتضحيات، ولّما علمَ أنهم مُقدمون على قتله والتخلّص منه، قدّم نفسه غير مُتراجعاً عمّا عاشه وبشّر به. لذلك كانت النعمة المُعطاة لنا بيسوع المسيح نعمة مُكلفة لا يُمكن أن نسترخصها برفضنا العيش مسيحيين. هذه النعمة كلّفت الله ابنه يسوع المسيح، وأحياها بدم طاهر، وحياة بريئة، فكيف لنا أن ننكرها بتجاهلنا وتقصيراتنا وهفواتنا؟
لربما لا نُريد نُكران حب الله لنا، ولكن فينا ما يمنع هذه المحبة من أن تدخل في حياتنا وتُغيّرها، هو كبرياؤنا. والرب عارفٌ بذلك، فنراه اليوم ينحني أمام تلاميذه، أمام الكنيسة، أمامنا وبيده المنشفة والماء ليغسل أرجلنا ويُحضرها للسير في طريقه، وأكثر من ذلك ليُخزي كبرياءنا، ووقارنا الزائف، فنقبل أن نُحَب. ربّنا يعرف قصورنا ونُكراننا وحتى خياناتنا، وينحني اليوم ليغسلها كلّها، ويُؤهل أجسادنا لتُضيء نوراً يمحو العتمة ويمنح الرجاء والأمل بالحياة.
في هذا العشاء يُظهر لنا ربّنا يسوع المسيح أن الأفخارستيا هي أكثر من خبز وخمر، هي حب وخدمة مَن هم من حولنا (غسل الأرجل). فلما نتقاسم الخبز مع الحائع، ونروي عطش مسكين، ونستضيف غريباً في قلوبنا، وفتح قلوبنا لمريض، ونستمع ونُصغي لأحزان الآخرين، عندها نعيش أفخارستيا يسوع. ففي الخدمة الصادقة يبدأ الإتباع الأمين التباعة الأمينة ليسوع.
فاقبل يا رب حياتنا تقدمة شكر، وأجعلها بخوراً طيباً للعالم كلّه، وعطر محبة نقي مُخلَّص من الأنانية والغضب والتعجرف والعنف والحسد والغش والخداع. أجعل يا ربّنا وإلهنا حياتنا كلمة سلام نتقاسمها في عراقنا المجروح، ولتكن كل أفعالنا يد رحمة تمسح دموع الحزانى، وخبزاً يُشبع الجياع، وماء يروي العطاشى إليك، وضيافة تُريح الغرباء والمُتعبين. إجعلنا يا رب خبزاً مُباركاً في قُداسك دوماً.
جمعة الآم: اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة
متى 26: 36-46
متى 26: 36-46
لا احد يريد الموت وهو بعد في الثالثة والثلاثين، بل لا يريد احد أن يموت في الأقل في نزاع على صليب. كل ما كان يعرفه هو أن مشيئة الله كانت تناديه وإستسلمَ للنداء، وقَبلَ الدعوةَ وخضعَ لها بإرادته، وأرادَ ان يكونَ خادماً. إيماننا يخضع للتجربة إلى أقصى حد عندما تصل تلك الأشياء، ولكل واحد بستان جستماني خاص به، وعلى كل واحد منا أن يتعلم ليقول: "لتكن مشيئتك!" لأننا نُصلي كثيراً ولكننا وعندما نسجدُ للصلاة أمام الله، نُريده أن يقف منتصبا أمامنا ليخدمنا ويخدم إحتياججاتنا. ويعطينا يسوع في البستان درسه الأخير في الصلاة. فليست الصلاة شيئا نقوم به من أجل أن نغير عقل الله، بل لنتلقى القوة لكي نفعل مشيئته.
كتبَ أحدهم عن الصلاة قائلاً: "أن تصلي يعني أن تموت. أن نموت في نطاق كامل عن ذواتنا، والتي نكون فيها جميعا أحياء إلى أبعد حد: هيجان وغرور وخوف ورفض واعتراضات. ويستغرق بنا الوقت طويلا لنموت، والموت مؤلم. لأن علينا أن نتركَ المكان الذي تعوّدنا عليه وإرتحنا فيها، لنولدَ لحياة جديدة: حياة الله، وهذا هو إختيارنا الأبدي، ومنه نستمدُ قوّتنا.
يُحكى أنه وأثناء الحرب العالمية الثانية، جرى تعذيب أسقفٍ كانَ مسجونا في احد معسكرات الاعتقال في ألمانيا من قبل احد ضباط الصف ليجبره على الاعتراف، وكان الرجلان يواجهان احدهما الآخر في غرفة صغيرة، يلحق احدهما الأذى بالآخر. لكن الأسقف الذي كان ذا قابلية كبيرة على تحمل الألم والتعذيب والأذى لم يتراجع عن مواقفه، بل قبلَ كل العذاب بصمت وشجاعة. صمتٌ أثارَ غضب الضابط إلى حد جعله يضرب ضحيته بشكل أقوى فأقوى حتى انفجر غضبا في النهاية وقال له: "ألا تعلم أنني استطيع أن أقتلك؟"
نظر الأسقف في عيني معذبه وقال له في بطء: "أجل، أعلم – افعل ما تريد – فانا ميت مسبقا، وحيٌّ لله ربّي..." فأصبح الضابط عاجزا عن رفع يده وفقد كل قدرة على ضحيته. وأصبح كأنه مصاب بالشلل. كانت كل قسوته مبنية على الافتراض بان هذا الرجل سوف يتشبث بحياته كما يتشبث بأغلى ممتلكاته، وانه مستعد للاعتراف في مقابل الحياة. ولكن مع ذهاب مبررات العنف، فإن المزيد من التعذيب أصبح غير مجد البتة.
ربّنا يُعلّمنا أن موته كان باختياره. فبعد أن عزم على الذهاب إلى أورشليم لعيد الفصح، كان من السهل عليه أن يغادرها دونما أن يلحظه أحدٌ، كان بإمكانه أن ينسل بعيدا في البستان، لان الوقت كان ليلا. كل خطوة في هذه الأيام الأخيرة توضح لنا أكثر بان يسوع كان قد تخلى عن حياته وبأنه مات، ليس لأن الناس قتلوه، بل لأنه اختار أن يموت على أن يتراجع عن بُشراه. أختار ربّنا يسوع أن يواصل المسيرة لأنه كان يعرف أن هذه هي مشيئة الله التي قبلها مؤمناً بأن المحبة هي الطريق الوحيد، وأن الحرب أو النزاع لا يحققان سلاماً بل تولدان شراً. شرٌ في النفاق والإفتراء على الناس وهذا يعني قتلهم روحياً ونفسياً، ثم قتلهم جسدياً. قُتِل كاهنٌ في غواتيمالا، فقال خليفته للجناة،" قتلتموه أولا بأفواهكم لسنوات قبل أن تقتلوه ببندقيتكم." الكلمات التي نستخدمها واحدنا ضدَّ الآخر قاتلة ومدمرة. وكلمة الله هي كلمة المحبة، كلمةُ غفران، كلمة رحمةٍ.
في كل ما يحدث لننظر إلى يسوع ونتأمل سكينته وسلامه، ثم لننظر إلى بيلاطس وقلقه واستيائه. ومن ثم لننظر إلى أنفسنا بينهما؛ هل هناك شيء تتعلمه من يسوع؟ أم من بيلاطس؟ من الواضح ان بيلاطس لم يكن يريد أن يحكم على يسوع: كان متأثرا بيسوع على نحو واضح. كان يعلم أن يسوع ثائر. لقد منح سكوته الوقور بيلاطس انطباعا بأنه لم يكن يسوع بل هو ذاته واقف هناك ليُحاكم. لقد شعر بيلاطس بقوة يسوع لكنه كان خائفا من الخضوع لها. لقد اعطاه الجبن سمعة سيئة كل الوقت. لقد بحث بيلاطس عن طريقة للهرب عبر تقديم خيار للجمهور. فأجابوا: "ليس يسوع المسيح، بل بارباس." لقد اختار الجمهور المجرم ورفضوا يسوع. لقد فضلوا رجل العنف على رجل المحبة والسلام. وهناك أخيرا الصورة الغريبة والمؤلمة لبيلاطس وهو يغسل يديه. واشتهرت كطريقة في محاولة إنكار المرء مسؤوليته عن أعماله. لقد سعى بيلاطس إلى تبرير ساحته من أية مسؤولية عن موت يسوع. لم يكن قادرا على الخضوع ليسوع مثلما نحن نكون غالبا خائفين من أن نكون مسيحيين كما يجب مثلما نعرف. ونعلم كذلك انه ليس من الممكن لا لبيلاطس ولا لأي أمرىء آخر أن يقول: "أنا بريء من أية مسؤولية." لا نستطيع أبدا أن نتخلص من تلك المسؤولية.
يروي لنا آباؤنا الروحين عن ثلاثة آباء إتادوا الذهاب لزيارة مار أنطونيوس المبارك كل سنة، واعتاد اثنان منهما مناقشة أفكارهما وخلاص نفوسهما معه. لكن الثالث كان يلزم الصمت دون أن يسأله شيئا. وبعد زمن طويل قال له أبتي: "غالبا ما تأتي هنا لتراني، لكنك لا تسألني شيئا أبدا." فأجاب الأخر، " يكفي أن أراك ، يا أبي!"
فأين أنت من كل ما جرى ليسوع؟
الجمعة العظيمة: إعتقالُ ربّنا يسوع
نقلَ الإنجيليون الأربعة قصّة الفصح الذي به قدّم يسوع نفسه كفارة عن خطايانا، وشهادة لحب الله لنا الذي لم ولن يتراجع أمام عذابات المُجرّب. فلقد قرر رؤساء الكهنة التخلّص من يسوع، فجمعوا الاتهامات، أعدوا الشهادات ضد يسوع. ولكنهم لم يرغبوا في أن يُحاكموا يسوع بتهمة دينية فيتحمّلوا وزرَ الحُكم، فراحوا إلى بيلاطس يطلبون موت يسوع بتهمة سياسية: إنه تحدى القيصر، وإذا لم تُحاكمه فلن تكون صديقاً لقيصر.
بادرَ ربّنا يسوع ولم ينتظر ليأتي أحدٌ فيأخذه، فذهب هو بنفسه إلى بستان خارج المدينة حيث أعتاد أن يجتمع مع تلاميذه، وهو مكان خاص جداً لا يعرفه إلا التلاميذ. وهناك حصلت مواجهة مع جماعة الظلمة بقيادة يهوذا. فبادر يسوع وسألهم: مَن تطلبون؟ هذا هو السؤال الذي واجه به يسوع معارضيه الذين أرادوا أن يُوقفوا نبضَ الحب السخي الذي أفاضه ربّنا على الإنسان. ربّنا هو الذي سأل كي لا يُعطي الفرصة لأحد لأن يتحكم بحياته، بل هو نفسه تقدّمَ بإرادته ليُواجه مُعارضيه، هو نفسه تقدمَ أمام تلاميذه، أمام الكنيسة ليقول: مَن تطلبون؟ وهو نفسه اليوم يسألنا: "مَن تطلبون"؟ عندما نُتابع المُحاكمات سنعرف أن مَن يُلقي الأسئلة هو القاضي أو الديّان، ومَن يُجيب هو المُتهم، هكذا يتقدم ربّنا إلى هذه الجموع ويسألهم مرة ثانية: مَن تطلبون؟
أجواء اللحظة احتفالية جداً: فيسوع مُحاط بتلاميذه، ويقف أمامه مُعارضيه من حرس الهيكل وحرس عظماء الكهنة والفريسيين ومعهم المصابيح والمشاعل والسلاح، كأنهم ومن غير قصد خرجوا لاستقبال العريس، الملك.
هي مواجهة بين عالم الظلمة الذي يحتضن كل مَن رفضَ يسوع ورسالته. وخطورة هذا العالم هو أنه يجذب أحياناً إليه بعض مَن تبعوا يسوع: يهوذا، فليس أحدٌ آمنٌ إذن، إلا الذي آمن بيسوع وبقيَ معه أمينا إلى المُنتهى. ربّنا يعرف هذه الساعة، ويريدها ساعة لتمجيد الآب الذي بشّر به محبة وحناناً، فلا يُريد أن تُنتهك فيرفض تدخل بطرس العنيف. ربّنا يُريد أن يسير أمينا في بشارته، فهو جاء لتكون لنا الحياة الأوفر، وأرادَ أن يكون لنا إصغاء حقيقي لكلمته، فكيف تتجرأ يا بطرس لتقطع أُذنَ الخادم؟ ولكن أوليس في ذلك رسالة لنا؟ فملخس، خادم رئيس الكهنة، أعطى أُذنا صاغية لرئيس الكهنة، وبالتالي لن يستطيع أن يسمع ويُصغي ليسوع، هوذا اليوم يتعمّذ بالألم فتُقطع له الأُذن التي تسمع للمُجرّب ولا تسمع ليسوع.
إسم يسوع يُثير فيهم الخوف والرعب لأنهم لم يُؤمنوا به، فداود المُزمّر يقول: أمامه يتعثّر الأعداء والمُضايقون (مز 27: 2). اسم يسوع أُلفة ومحبة لمَن يُؤمن به، ودينونة مُخيفة لمَن لا يُؤمن به. ولكننا نفهم تراجع الحرس وخوفهم انتصاراً ليسوع في بدء المواجهة، ودليل ضعف المُعارضين، فسقطوا كلّهم أمام هدوء يسوع وصلابته وثباته.
في هذه الساعة لا ينسى يسوع تلاميذه، خاصته، كنيسته فيحميهم ويُبعدهم عن الخطر، لا بل يفتديهم. كنيسته، نحن الذين نُعاني الظلمة والحيرة في حياتنا، نحن حاملو المشاعل والمصابيح، النور الذي لا يُوصلنا إلى الحقيقة. لم يفقد يسوع أيّاً من خاصته، بل وقفَ مُدافعاً عنهم، تقدم إلى الموت بنفسه وقدّم نفسه طواعية كي لا يُمسك أي منهم. تقدمهم لتكون لهم الحياة، فإذا ما نالوها، قدموّها هم أيضاً من أجل حياة العالم.
أُقتيدَ ربّنا يسوع إلى بيت حنان كسجين مُقيّد بالسلاسل ومُحاطاً برجال مُسلحين. بالطبع لقد هدد ربّنا سلطتهم وأضرَّ بالهيكل وتجارته التي كانت تدرُ لهم ربحاً وافراً. ومع أن استجواب يسوع ومُحاكمته كانت باطلة إذ لا تسمح الشريعة اليهودية باستجواب شخص ليلاً. يوحنا الإنجيلي يُخبرنا أن بطرس تبع يسوع، ولكن الذي رافقه عن قٌُرب كان التلميذ الحبيب. وفي الساعة التي فيها يواصل فيها ربّنا إعلان رسالته، في تلك الساعة نتفاجأ بنُكران بطرس ليسوع، الذي يخاف المواجهة. إلا أن ربّنا يسوع بقي أمينا لرسالته، فأعلن أمام عظيم الكهنة، الذي كان له سُلطان قوي على الشعب في تنظيم الاحتفالات ورعاية حاجات الشعب، فكانت السلطات الرومانية تحسبُ لهم حساباً خاصاً. أعلنَ أنه تكلّم علانية ومن دون أن يخاف أحد في المجمع والهيكل، فاسأل الذين سمعوني عمّا كلمتهم به، فهم يعرفون ما قُلتُ.
ربّنا يعرف جيداً أنهم حكموا عليه قبل أن يُحضره إلى المحكمة، فهم أرادوا التخلّص منه بوسائل شتى. حتى أنه الجميع تحالف ليقتل مَن أرسله الله لخلاص الأمم، ولكن الله سيُبدد مؤامراتهم ليُعلن كما أعلن بفم المُزمّر: أني أبني وأنا اليوم ولدتُكَ.
فإذا ما سألنا عظيم الكهنة عن تعليم يسوع، لأننا نحن أيضا سمعناه في كنائسنا فهل سنستطيع الإجابة؟ وماذا سنقول عنه؟ هو مُخلصّنا؟
كان الوالي الروماني آنذاك يُقيم في قيصرية، ولكنه كان يتواجد مع عساكره في أورشليم أيام الأعياد الكُبرى خوفاً من المُشاغبات. لم يدخل رؤساء الكهنة دار الوالي الروماني خشية أن يتنجسوا، فيمنعهم ذلك من أكل الفصح، إذ أن اليهود يحسبون دور الوثنين نجسة. هكذا الإنسان لا يُمانع أبداً من إهلاك دمٍ برئ، ويقتل وبدم بارد إنساناً مُحباً، ولكنه يستصعب طقوساً سطحية فيُحافظ عليها، صدق ربّنا إذ قال فيهم: يُصفون الماء من البعوضة ويبلعون الجمل (مت 23 : 24). بالطبع هم يُريدون أن يُقدموا إنساناً واحداً لئلا تهلك أمة كاملة، ويُريدون أيضاً أن يُقدموا الفصح، ولكن الله أعطاهم الفصح الحق.
بيلاطس مُتحيّر ما بين الحقيقة التي يراها في يسوع، وما بين كذب رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. لذلك كان يجيء ويذهب ما بين يسوع وبينهم مُتقلباً في الآراء، يبحث عن الحقيقة، مثلما نبحث نحن أيضاً عن الحياة الحق ما بين ما يُقدمه لنا يسوع والكنيسة، وما بين العالم وأكاذيبه. يُريد المُساومة لكي يختار معاً، ولكن هذا مُحال. يتنازل بيلاطس أخيراً أمام إلحاح رؤساء اليهود وخُبثِهِم. لقد اتهموه بأنه يدّعي الملوكية وهذا يُعادي القيصر.
لقد ثبتَ يسوع أمام بيلاطس القلق الحائر ولم يفرض نفسه بالقوّة بل قدّم ذاته ملك الحقيقة، فعليك أن تختار يا بيلاطس. فكل مَن يطلب الحقيقة مؤمناً بالله سيقبل يسوع المسيح مُخلصاً. يقف يسوع أمام بيلاطس والعالم كلّه شاهد على الحقيقة، ويحوّل يسوع اللقاء مع بيلاطس هذا ليكون محكمة لبيلاطس نفسه، يسوع هو الذي يطلب من بيلاطس المًتهَم أن يُعلن موقفه. فيتهرب بيلاطس من المواجهة ليذهب ويُقابل رؤساء الكهنة، ويقول لهم مُرائياً أنه لم يجد سبباً لإتهام يسوع.
يُسلّم بيلاطس يسوع إلى العذابات لعلّه يُهدئ رؤساء الكهنة في رغبتهم العارمة في الخلاص من يسوع، وفي قمة هذه العذابات يُتوّج بإكليل الشوك ورداء أرجواني وصولجان الرعاية مع تحية الجنود له: يا ملك اليهود. هذا هو الطقس المُتبّع في تتويج الملوك وهو ما يناله يسوع على الرُغم من سوء نية الجنود. وحتى بيلاطس نفسه، والذي يُمثل الإمبراطور الروماني، أعلى سلطة مدنية، يعترف لمّا يُقدِم يسوع قائلاً: هوذا الملك (يو 19: 14). عندها نسمع صرخة غريبة: أصلبه، وهو قرار الشعب الأخير في رفض يسوع. فماذا سيفعل بيلاطس الخائف من الحقيقة، والذي حاول أن يُراوغ إلى الآن؟
كُلنا يُراوغ مثل بيلاطس أحياناً كثيرة ليكون قُربَ يسوع، ويلتزم بما يُريده العالم. هذا لا يعني أن العالم شرٌ، فنحن من العالم ولكننا دُعينا لنعمل، ليكون العالم بمثل ما يُريده الله. إلهنا يحلم بعالم يسوده السلام ويتكلم لغة المحبة ويقبل واحدنا الآخر بالطيبة والحنان. وسلاطين العالم تريد التسلّط مُتعالية لتسحق الجميع وتُثبّت رغباتها. ربّنا أتى ليُبعد كل هؤلاء عن هيكله ومقدسه، فلهذا يُحارب العالم يسوع والمسيحية، لأنها كنيسة تحمل قيم وفرص حياة كريمة للإنسان. فلا مجال للمُراوغة: إما يسوع وإما العالم.
كان يسوع قد علّم الكنيسة والعالم كيف تكون السيادة، بالخدمة. فقام وغسل أقدام تلاميذه وفي ذلك علّمهم ما هو باقٍ، فعليهم أن لا يخافوا خدمة الناس. أما بيلاطس فنراه خائفاً ولا يريد أن يخسر هيبته ومكانته فيُضحي بيسوع. لقد نال بيلاطس لقبَ "صديق قيصر" وهو لا يُريد أن يخسر هذا اللقب، على الرُغم من أن الله يعرض عليه صداقة يسوع. بيلاطس متأكد من براءة يسوع، وهنا يسألنا يوحنا: يا مسيحي صداقة مَن ستختار لحياتك؟ إذا أردت صداقة العالم فأبقَ مع بيلاطس، أما إذا أردت صداقة يسوع، فاتبع يسوع.
لقد طلب رؤساء الكهنة والشعب من بيلاطس أن يصلب يسوع، أن يقتل انتظارهم للمك المُرتقب للمسيح في مدينة الملك الداودي، وهكذا حكموا على أنفسهم في وقت مهم من احتفالية الفصح، وقت ذبح الحملان التي تُمثل ساعة دينونة الله للعالم. وهم لا يدرون أنهم يُقدمون لله حملاً عن خطاياهم، وما يتصورونه إنها ساعة إهانة يسوع، ستكون وستبقى ساعة تمجيد يسوع. فخرجَ يسوع يحمل صليبه، الصليب الذي هو عقاب العبيد، إذ أنه أقسى العذابات، ولكن لا أحد ينكر أن يسوع ملك، فلقد كُتبَ على صليبه بالآرامية لغة الناس أنه ملك. كُتبَ باليونانية لغة الإمبراطورية أنه ملك. وباللاتينية لغة الرومان المحُتلين أنه ملك. فلقد كانت مُلوكية يسوع للعالم كلّه على نحو قاطعٍ، ومَن ينكر ذلك يُكذّب ما كُتبَ وما قيل. وهو تحدٍ لنا: ماذا أنتم فاعلون؟
إننا نتعجّب من عظمة محبة يسوع ووفائه لله، وكيف أن هذا الحب ما زال مجهولاً، فيسألنا ربّنا: ماذا فعلت لتُعرّف الناس والعالم بهذا الحب؟ حمل يسوع الصليب لأنه حمل إلينا أولاً حب الله وحنانه، فهل نحن مستعدين لنحمل هذه المحبة للعالم ولمَن هم من حولنا؟ رافق يسوع أمه والتلميذ الذي أحبه يسوع، فهل لنا استعداد لنُرافق يسوع نحن الذي أحبَّنا حتى الموت؟ ربّنا يُعطينا أمه لتكون لنا أماً فتُعطينا الحياة مثلما أعطتها له، فمَن منّا مستعد لقبول مريم في بيته الخاص، في قلبه وحياته؟
الجمعة العظيمة: لماذا الصليب
علينا أن نفهم أولاً وقبل كل شيء أن صليب يسوع هو رفضٌ للشر، هذا هو إيماننا المسيحي. موت يسوع ليس ميتة جميلة وإلا فلماذا السواد هنا. ليس في الموت من جمال أبداً. إنه إبعاد، غُربة عن الحياة، الأهل والأصدقاء. ولم يمت يسوع ميتة الأبطال، بل هو متروك من الناس ومن الأصدقاء والأقارب، حتى أنه يصرخ إلى الله: إلهي إلهي لماذا تركتني.
هناك الكثير من الناس مُعلّقون على الصليب، المرضى، اليائسون من الحياة، المسحوقون من الواجبات، من الضجر والملل، المُتضايقون من القلق، المُسممَّون من الحقد، المنسيون من الأصدقاء، المهملون من الآخرين، المتألمون من الخيانات، الخصومات مع الأهل والأصدقاء، حسد وطمع وجشع الناس…هذه كُلها بسبب الناس ويذهب ضحيتها أناس. أترون كُلنُّا مُعلّق على صليب، فمن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. جئناك يا يسوع لنكون معك، فقوّنا لنسير الطريق بأمانة.
صلبُ يسوع قضية بشعة، قبيحة. إنه لغة العنف والشر التي يُمكن أن يُنزلها الإنسان بأخيه الإنسان رافضاً إياه، ومنكراً عليه حق الحياة. لم يطلب يسوع الألم، إنما فُرض عليه. لم يختره، بل حاربه بكل أشكاله: أشفى المرضى، حرر الخطاة. الألم ألمٌ، وهو مُوجِع. الاقتداء بيسوع لا يعني طلب الألم والصليب: إنها هرطقة. بل يعني: أن أتحمّل ما يُصيبني أنا –في وضعي هنا والآن- من ألم مُجاوباً آلام يسوع. مَن أراد أن يتبع يسوع، فلينكر ذاته ولا يحمل صليب يسوع، ولا يحمل صليب هذا أو ذاك من الناس، بل صليبه هو ويتبع يسوع (مرقس 8: 34). ترانا دوماً نتهرب من صُلباننا، إلتزاماتنا المسيحية، ونُحمل صُلباننا على الآخرين. لنفحص ضمائرنا إذن، على مَن وضعتُ أنا صليب حياتي؟
منذ البداية عرفت الجماعة الكنسية أنها مدعوّة للاعتناء بالآخرين. إنها مدعوّة لتُحارب ألم الناس وضيقهم. أن تتنازل عن طريقها وتُؤجل مشاريعها من أجل حياة الآخرين. وهكذا اهتمت المسيحية بالمرضى والمتروكين وهي علامة ولائها وأمانتها للرسالة التي تحملها في العالم. أرادت دوماً أن تُحارب الألم والجوع والفقر والمرض. فلا يجوز أن نعفي أنفسنا من هذه الرسالة والمسؤولية أبداً. علينا تغيير المجتمع ليكون عالماً حسنناً جداً للناس أجمع.
علينا جميعاً وبسبب صليب يسوع أن لا نُسكت الآخر ونتنكّر لحقوقه، بل نحاوره، نلتقيه. يكفينا حبس الآخر في ضيق أفكارنا ومفاهيمنا وتصوراتنا وكأننا نحن الذين خلقناهم. علينا أن نُزيل كل صراخ وأنين وتنهد وولولة وبكاء ووجع وحزن، نحن مدعوون مثل إلهنا أن نمسح كل دمعة من العيون، فلا يكون للموت سلطان على البشر، بل تكون سماءً جديدة وأرضٌ جديدة (رؤيا 21: 1- 4) لننتبه إلى أن الوعد بمستقبل بلا ألم ليس حُلماً، بل أن نكون من الآن مسؤولين عن حياتنا، تصرفاتنا، سلوكنا، كلامنا هنا والآن بحيث يكون الغد من دون ألم. الوعد بمستقبل آمن ليس تهرباً من الحاضر، بل كيف وماذا أعمل بحيث يكون يوم غد أكثر طمأنينة للجميع؟
لقد صلب يسوع إنساننا العتيق الأناني الذي يرغب براحته وسعادته فوق كل اعتبار. لقد خلّصنا من إنساننا الذي يسحق الآخرين ليكون هو سعيداً مترهفاً. لقد حررنا من إنغلاقنا الأناني: أنا فحسب. لنسمع ونصغي إلى الآخرين. لقد وُلدنا مع يسوع لحياة جدية، حياة من أجل الآخر، حياة من أجل الله. والله ليس لنفسه، بل هكذا أحبنا للغاية حتى أنه بذل أعز ما لديه من أجلنا. نحن صورة الله ومثاله: أي نحن إذن من هذه الدعوة؟ ربّنا وإلهنا قونّا نحن الضعفاء لنُكمل صورتك في العالم ونعكسها. ربّنا قوِّنا إيماننا بك.
المسيحي الذي يحارب الألم يقول مع بولس: "يُضيّق علينا من كل جهة ولا نصهر، نُحار في أمرنا ولا نيأس، إنّا مُضطهدون لا مخذولون، إنّا مُجدَّلون لا هالكون، مائتين وها نحن أحياء، مُعاقبين ولا نُقتل، محزونين ونحن دائما فرحون، فقراء ونُغني كثيرين، لا شيء عندنا ونحن نملك كل شيء .(2 قور 4: 8-9/ 6: 9- 10)
حياتنا صلبة فيها من الوجع والألم ما فيها من سعادة وفرح. ولكن إنطلاقاً من صليب يسوع يكون لها معنى. من الآن ليست حياة ألم من دون معنى، بل طريق للقاء الآخر، الله. يا إنسان هل أنت مستعد لتسير في هذا الطريق؟ احمل صليبك، ألمك، ضيقك، وجعك وسّر بجانب يسوع. لا تستسلم للألم والوجع والموت، فما من قوة تتغلب على نعمة الله الذي أقام يسوع من بين الأموات، فهو أولاً إله حاضرٌ معنا.
لم يأتِ يسوع ليُصلب، ليموت بل ليحيا ويجمع الخراف الضالة، يُعدّ للرب شعباً. ولكنه يُصلب من أجل طريقة حياته، بسبب رسالته، فلا نفصل الصليب عن حياة يسوع أبداً. تُعلمنا الكنيسة أن يسوع نزل إلى مثوى الأموات، وادي الدموع ليُحي الأموات ويُصعدهم معه إلى الآب. المائت يُحيي ويُعطي الحياة. ولكنه يُحيي لأن الله أرسله للحياة. أنت يا مَن قُلت: طوبى للفقراء، للرحماء، للمعوزين، للجياع، للعطاش……..أنت ابني وأنا رضيتُ عنك. الله أقامه، وبإقامته أكد لنا، أيَّ شكل من الحياة يُريدنا أن نعيش، حياة مثل حياة ابنه، أن نكون مسيحاً آخر لمن هم من حولنا. الخلاص إذن ليس في الصليب، بل في المصلوب. الله لا يُجمّد ولا يُعظم الآلام، بل ابنه المتألم، لا بسبب الألم، بل لأنه أمين معه. يسوع هو صوت الله على الأرض، إنه الله معنا؛ عمانوئيل.
يقول مار بولس: مات المسيح لأجلنا (روم 5:
إذا كان في الصليب من بشارة لنا: فهي: يا إنسان اعلم أن الله يُحبك، ويُريدك معه. جاء وصالحك بيسوع. كان أميناً معك حتى الموت. أنت مدعوٌ للعودة إليه، هو ينتظرك. فلا تُقسِ القلب، لا تُغلق أبوابك بوجهه. إرجع إليه، افتح له باب حياتك ليدخل عندك.
عيد القيامة:
فرأت الحجر مرفوعاً عن القبر (يو 20: 1)
فرأت الحجر مرفوعاً عن القبر (يو 20: 1)
عيد القيامة: رأس أعيادنا المسيحية وسبب وجودنا ككنيسة، فإن كان المسيح ما قام، فتشيرُنا باطل، وإيمانكم باطل، بل نكون شهودَ زورٍ على الله ... (1كو 15: 14- 15). عيد القيامة، عيد النور بعد ظُلمة جمعة الأحزان، جمعة الخيانة والنُكران، جمعة الخطايا التي تريد قتل الحياة التي يفضيها الله علينا. فلنفرح ولنُعيّد عيدنا بالشُكران والإمتنان، لأن الله رفَعَ عن حياتنا حجر جهالتنا، وفتحَ أمامنا طريقَ الرجاء، لأنه أحبّنا، وأحبنا حتى المُنتهى.
أتت مريمُ باكراً تُعاين القبرَ. جاءت مريمُ تبكي الميّتَ من دون أن تعلمَ أن الله حضّر لها ولنا، فرحاً لا يُريد كلماتٍ أن تصفه، بل يُريد قلوباً تستقبله بالصدق والأمانة، فتعيش قيامة ربنا يسوع، بُشرى سارة بين الأخوة والأخوات. ربنا يسوع الذي قَبِلَ محبّة الله بطاعة كاملة، فعاشها بيننا حناناً ورحمة وطيبة، ولم يتنازل عن البُشرى السارة: الله محبّة، ولم يتراجع عنها أمام تهديد الألم والعذاب، ولم ينحني أمام التجارب، بل بقيّ مُستسلماً لإرادة الله، مؤمناً أن في المحبّة كل الحياة، وهكذا لم يتمكن الموت من أن يغلب الحياة، بل إنهزمَ البُغض أمام المحبة.
"فرأت الحجر مرفوعاً عن القبر"، تشرح هذه العبارة مفهوم خبرة القيامة كلّها: رُفعَ الحجر الذي كان يمنعنا من الدنو إلى الله أبناء مُبررين له. الحجر، خطايانا التي تمنعنا مراراً من الإقتراب إلى الله أبينا، غُفرَت لنا اليوم بفعلِ محبّة الله، لأن الله نفسه يُريدنا قريبين منه على الرغم من رفضنا وتعنّتنا ونُكراننا وخيانتنا. حياتنا مليئةٌ بأحجارٍ كثيرة، بُشرى القيامة اليوم هي: أن ربنا رَفعَ الحجر عنّا، فلنقترب إليه فرحين، ولنعلن بشهادة حياتنا: أنه رَفَعَ عنّا الحجر فلا نخاف بعد اليوم.
ولكن لننتبه، فربنا يُريدنا أن نُعلنَ قيامته: "إذهبي إلى أخوتي وقولي لهم، أنا صاعدٌ إلى أبي وأبيكم، وإلهي وإلهكم". (20: 17). ربنا يطلّب منا بُرهان إيماننا بقيامته، فالخبر هو "قيامة ربنا، والمضمون هو" مسيحيون فرحون برجاء القيامة. ربنا ينتظر منّا أن نُظهِرَ للعالم أجمع جوهر رجاءنا هذا، وكيف نعيش قيامته وغُفرانه. إلهنا يقترب إلينا كي لا نبقَ في تيهنا وضياعنا، ويُشجعنا لكي نتجاوز مخاوفنا ونتغلّبَ على كسلنا، ونقفَ أمام العالم كلّه شهوداً لفرح القيامة، كيف؟
لا بالعودة إلى الماضي، إلى الميت والبكاء أمامه، وتطيبَّ جسده بالدموع والشموع والصلوات. مسيحيتنا تقبل تمرُ بجمعة الآلآم، ولكنها سائرة إلى فرحِ القيامة. وهذا يتطلّب وفاءً وأمانةً لفعل الله في حياتنا: إنه رفعَ عنّا الحجر. فإذا نظر الناس إلينا هل سيكتشفون في حياتنا نتائج قيامة ربنا يسوع المسيح؟
للوهلة الأولى، ومن نظرة إلى المظهر الخارجي، لربما سيعرفون من ملابسنا أننا نعيش مناسبة كبيرة، أو عيداً عظيماً. ولكن الأهم من كل ذلك، لو تأملوا حياتنا، وزاروا قلوبنا، هل سيفرحون بأننا نُعيّد قيامة ربنا يسوع المسيح؟ هل سيختبروننا نوراً وملحاً وخميرة؟
"يُحكى عن رجلٍ شريفٍ فكّر بأن يُكرِمَ أبناء قريتها بهديةٍ ثمينة، فبنى لهم كنيسة في القرية. أشرفَ بنفسه على البناء، ولم يدعَ أحداً يتدخل في تشييدها، وعند يوم الإفتتاح، إجتمعَ السُكان حول الكنيسة، ودخلوها فإندهشوا لروعتها وجمال الرسوم والنحوت التي فيها. ولكن المُفاجأة كانت أكبر، حين أوعزَ هذا الرجل لمساعديه بأن يُوزعوا فوانيس لكل عائلة، وقال لهم: "ليس في الكنيسة أي مُصباح، بل أن المصابيح معكم، فإذا لم تأتوا إلى الكنيسة، فإعلموا أن هناكَ مكاناً في كنيسة سيبقىَ مُطلماً، لأنكم لم تحضروا".
إخوتي وأخواتي، العالم كلّه ينتظر تبشيرنا بفرحِ القيامة. فإن كان في العالم من ظلمة وتعاسة وظلمٍ وإجحافٍ ومهانة، فهذا موجود لأننا كمسيحيين نُفضل التغيبَ عن حضورنا المسيحي، والعودة إلى الأمس، عوض التطلّع إلى رجاء القيامة.
القيامة، مصباح أمّنه الله بين أيدينا، لنسير الحياة ونُنير ظلمة مَ، هم من حولنا، فلا نتقاعس عن رسالتنا، ولنحمل مصابيحنا، وننطلق مُبشرين العالم أجمع بشهادة حياتنا، بصدقنا ونزاهتنا، بتواضعنا ومحبتنا، وهذه كلّها تطلبُ جُهداً أكثر من جُهدِ تطييب جسّد ميّت. لربما نُفضّلُ مثل التلاميذ الإختباء والصمت وعدم الكشفِ عن مسيحيتنا خوفاً أو خجلاً حيرةً، ربنا يأتينا ويطلب منّا العودة إليه. ربنا يأتينا ليقوي ضُعفنا، وينزع عنّا كل خوفٍ وشكٍ وحيرة.
القيامة تدعونا اليوم لنختار: إما أن نكون حجراً يقبرُ حياة المحبّة التي عُمّذنا فيها، ويدفنُ مسيحيتنا بكل ما حملهُ من فضائل وقيمٍ نيرةٍ لعالمنا. وإما أن نكون، على مثال بُطرس، حجراً قوياً راسخاً بالله يبني ربنا عليه كنيسته.
فإعنّا يا ربُ في يومِ قيامتِكَ، أن نكون الحجارة المُختارة لبناء عالمٍ تسوده المحبة ويعمُ فيها السلام، بما نحمله نحن في حياتنا من رحمةٍ وطيبٍ وغفران. ونطلبُ منك اليوم خاصةً، أن ترفعَ حجرَ الحزنِ والعنفِ والمًخاصمة عن بلادنا العراق، ليكون عراقنا خدرَ الفرحَ والآمان لشعبهِ وأبنائه.
عيد القيامة
ويوم الأحد جاءت مريم (يو 20: 1)
ويوم الأحد جاءت مريم (يو 20: 1)
آتت مريم إلى القبر أول الناس لتُطيب جسدَ مَن مدَّ لها يد رحمة الله وطيبته. آتت مريم وكُلّها حُزنٌ لأنها لن تسمع صوت المُعلّم والرب مرة أُخرى. ولكن حُزنها يتعمّق أكثر عندما لا ترى حتى جسده: لقد أخذوا الرب ولا أعلم أين وضعوه؟
مريم التي لم تُبالي بالمخاطر للوصول إلى القبر. مريم التي تخرج خارج أسوار المدينة وحدها لتصل إلى القبر. مريم التي تتجاوز خوف التلاميذ وحيرتهم لتواصل مسيرتها بلهفة وشوق عظيم. مريم وعلى الرغم من كل ما تلقاه الرب من عذاب وإهانة تبقى تؤمن به ربّا. مريم التي تريد أن تستيقظ لتكون أول زائر للقبر، فيُباركها الرب بأن تكون أول شاهد وأول بشير. هي تُسرع إلى بطرس وإلى التلميذ الذي يُحبه يسوع وتُخبرهم بأن الحجر قد رُفِعَ، وهو بدوره يركض إلى القبر، يدخل ويرى اللفائف موضوعة هناك والمنديل في موضع على حدة، وهذا يعني أن الجسد لم يُسرَق مثلما أشاع رؤساء الكهنة في حينها.
دخل بطرس والتلميذ وشاهدوا ما في القبر ورحلوا وهم أكثر دهشة مما كانوا عليه قبل وصولهم إلى القبر. أما مريم فمحبتها سمّرتها في مكانها لتنعم بمٌشاهدة الملاكين حيث وُضع جسد يسوع. فالمكان كلّه مُبارك بحضور إلهي. هم موجودون حيث وِضعَ الجسد، لكنهم جاؤوا ليكون لحضورهم فرصة للحياة والفرح. جاؤوا ليُحولوّا الحزن والبكاء إلى بشارة وتهليل.
مريم لم تعرف ربّنا القائم لأنها كانت غارقة في الحزن والبكاء، وهو ما يمنع من الإيمان بالفرح. ناداها باسمها، فهو الراعي الصالح الذي يعرف خرافه بأسمائها. عرفت الصوت، إنه صوت المُعلم وللحال تفرح وتبتهج، وتحاول أن تُمسكه كي لا يأخذه أحدٌ منها. وربّنا يُرسلها لتبشّر أخوته، تلاميذه، الكنيسة، نحن بأنه ماضٍ ليلتقي الآب الذي بشّرنا بمحبته. فالرب بموته وقيامته جعلنا أبناء الله وأخوة له.
فمن عمق أحزان التلاميذ إذ يشعرون بالألم لما حصل للمُعلم، فرجاؤهم قُتلَ، وآمالهم ضاعت. يشعرون بالذنب لأنهم تركوه، ويُوبخون أنفسهم لجُبنهم وخوفهم، فيشعون بأنهم ضيّعوا كل شيء: تعبنا الليل كلّه ولن نصطد شيئاً ... هذا ما قالوه للذي نادهم من اليبس يطلب مأكلاً. من عمق هذه الأحزان، يُشرق الرب عليهم نوراً يمحي ظلمتهم، شرط أن يُؤمنوا، يطيعوا، فيُلقوا الشباك حيثما يُريد هو لا حيثما يرغبون.
فإن كُنّا نحزن لما يُصيبنا من الآلام، ونحتار لما نختبره من أوجاع وصعوبات، فالهرب ليس حلاً، والسكون حيث الحزن والوجع ليس خلاصاً، بل البحث والبقاء عند المُخلّص يسوع البشير، فهو قادرٌ على أن يُنير ظلمة حياتنا إن ثبتنا مُخلصين له: رابوني، يا مُعلم. فمَن ذا يُمكن أن يكون مُعلماً لحياتي إلا الرب يسوع المسيح.
أعتاد الكهنة في القرون الوسطى للمسيحية أن يُهيئوا قصصاً مُفرحة، وحتى مواقف طريفة ليقولوها في موعظة عيد القيامة ليُغيّروا جو الحزن الذي صار للرعية يوم جمعة الآلام. فالقيامة وقت للفرحة، زمن للتهليل، ساعة يبتسم فيها الله لنا بعد صراع مع الموت.
فلربما تشعر بأنك مرفوض من قبل الأصدقاء، وكلامك لا يعني لهم شيئاً. لربما تختبر أزمة عويصة تُقلق نومك وتُجهض سلام حياتك. لربما تبكي لعدم إيجاد فرصة عمل، ورزق آمن، واستقرار لحياتك وعائلتك. لربما تعيش زواجاً مُحزناً وعلاقة مُؤلمة. لربما تشعر بأنك غير محبوب وغير مرغوب فيه. لربما فقدتَ الأمل بأن هناك أمل في حياة آمنة ومُستقرة في بلادنا، ولا مجال للسلام أن يكون. لربما فزعت من قوى الشر التي تنتهك وتقتل العشرات يومياً، وتُجهض على أحلام الفقراء.
فمهما يكن ألمك تأكد أنت لست وحدك فالرب يسوع معك، ولأجلك يواصل طريق البشارة: الله يُحبنا ولن يتراجع عن هذه البشارة. ففي وقت أزماتنا ومشاكلنا ترانا نستشير الجميع إلا الله الآب. ولربما سمعتم قصة ذلك الولد الصغير الذي كان يحاول رفع حجر ثقيل جداً ولكن من دون جدوى. فحدث أن مرّ والده فوقف يراقب جهوده. وأخيراً قال له: "يا بنيّ هل استعملت كلّ ما بإمكانك لرفع الحجر؟" فأجاب الولد والإرهاق بادٍ عليه: "بالطبع يا بابا!" فقال له والده بهدوء: "لا يا بنيّ! لم تستعمل كل ما بإمكانك! لأنك لم تطلب مني أن أساعدك".
فاسمح للرب بأن يعمل في حياتك، واترك له المجال ليُحبَ من خلالك، وأن تكون يداك وكل أفعالك فرصة ليُقرّب الرب ويُعدَّ له شعباً مُباركاً. هذه هي قوّة قيامة يسوع فينا، فلا يكفي أن نعرفه، بل أن نُعرّفه ونشهد له في حياتنا، وهو يتطلّب أن نذهب مثل مريم اليوم لنُبشّر أخوتنا بأننا: رأينا الرب في حياتنا.
 مواضيع مماثلة
مواضيع مماثلة» تأملات
» تأملات في العنصره
» تأملات في المعموديه
» تأملات للبشريه جمعاء
» * تأملات في كتاب لاويين:18 - تفسير
» تأملات في العنصره
» تأملات في المعموديه
» تأملات للبشريه جمعاء
» * تأملات في كتاب لاويين:18 - تفسير
النوفلي :: المواضيع الدينية :: عظات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى





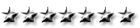


» رمش عيد ختان الرب 2022
» الجمعة الرابعة من السوبارا
» تشبوحتا
» شبح لالاها معشنان
» تشبوحتا دمثأمرا بسهرة الحش يوم خميس الفصح بعد الانجيل
» شليحا دعيذا قديشا دقيمتيه دمارن
» قريانا دعيذا قديشا دقيمتيه دمارن
» قولاسى دقوداشا تليثايا تسجيل جديد